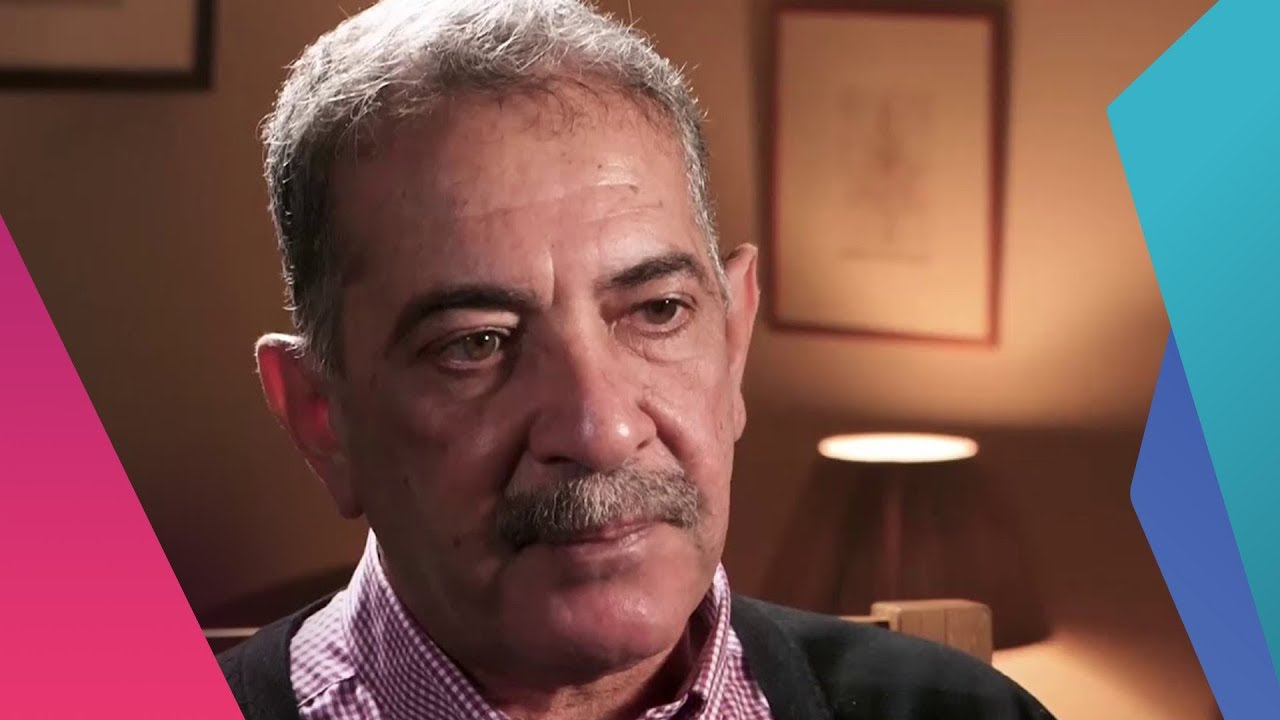
غير زعيم عربي قالها بصراحة “مَن لا تعجبه الأوضاع فليرحل” كما لو أن الوطن بيت شخصي ورثه أولئك الزعماء عن آبائهم. هو ملكهم الشخصي الذي يجب ألا ينافسهم أحد عليه.
هل يأتي يوم يكون فيه الجميع من غير وطن؟
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقبال المزيد من اللاجئين السوريين. هناك إذاً لاجئون سوريون في الطريق.
مسلسل اللجوء العربي لن يتوقف. دائما هناك حلقات جديدة منه تشهد على تدني المستوى الإنساني في العالم العربي.
يشعر الكثير من العرب أن اللجوء صار هو الحل الذهبي حتى صار مهنة يمكن أن يمارسها المرء وليس خيارا اضطراريا.
الهروب من الوطن الحقيقي إلى وطن سيظل دائما افتراضيا أو وطن يمكن اختصاره بأوراقه المريحة. تلك هي المحصلة.
أجيال تولد في الشتات تطاردها فكرة الهروب من ذلك الوطن باعتبارها الإرث الوحيد الذي يثقل ضميرها بالرغم من أنها لا ذنب لها فيه.
تلك هي أجيال مضيعة الإرادة وستبقى ضائعة لأنها لا تملك جذورا في الأرض التي احتضنتها وأكرمتها ورعتها.
العرب غير مؤهلين للقيام بشيء سوى أن يرحلوا من بيوتهم ليقيموا في أماكن مؤقتة. مهما طال العمر فإن ذلك البيت لن يكون بيتك.
هواية تحولت إلى مهنة. ومن أفراد يفضلون الهجرة إلى مجتمع هارب من إرادته. من نزعة شخصية في التمرد إلى عصف يحمل المجتمعات إلى تغيير عاداتها والتخلي عن تاريخها.
ما هذا اللعب بالمصائر الذي تمارسه الشعوب؟
لاجئون من أجل لا شيء. ليس صحيحا. كل لاجئ هو رقم في معادلة دولية ستُمحى من بعدها الأوطان ليكون الجميع من غير وطن
لم يكن كل الذين وصلوا إلى دول اللجوء هم في حاجة ماسة إلى الهروب. “الذين يستحقون الحماية لم يصلوا” ذلك ما يمكن أن يستنتجه المرء وهو يبحث بحياد في ملفات اللاجئين القادمين إلى أوروبا من مختلف الدول بهويات سورية. ذلك ما فعله العراقيون من قبل وما يفعله الأكراد حتى اللحظة.
أليس من المضحك أن يكون أكثر من مليون كردي سوري وعراقي وإيراني قد حصلوا على حق اللجوء بحجة أنهم من الناجين من القصف الكيمياوي في حلبجة العراقية؟
ذلك ما دفع منظمات إنسانية إلى أن تطالب الدول بالتخلي عن قوانين اللجوء. وهو ما شجع الأحزاب اليمينية في أوروبا على أن تضع طرد اللاجئين المسلمين فقرة ضمن برامجها الانتخابية.
لأغراض نفعية مريبة شجعت الدوائر السياسية الغربية على زيادة أعداد اللاجئين القادمين من دول بعينها. حدث ذلك مع العراق يوم كان يحكمه صدام حسين لكي يُقال إن نظاما يطرد أربعة ملايين من مواطنيه لا يستحق البقاء بل يجب الانقضاض عليه وإسقاطه. وحدث ذلك مع سوريا قبل أن تبدأ الحرب حيث أقيمت مخيمات في الأردن وتركيا اعتقد السوريون أن الإقامة فيها ستكون مجرد تمهيد للانتقال إلى أوروبا. ما صدقه السوريون يومها لم يكن حقيقيا.
وقف العداد عند رقم العشرة ملايين. ذهب سوريون إلى الموت غرقا في مغامرة اللحاق بإخوتهم ، في الوقت الذي شعر عراقيون فيه باليأس من عبور حدود روسيا البيضاء إلى أوروبا الغربية. مَن نجا عاد بحكايات ولا أحد يلومه على ما فعله بنفسه. ولو خُير الناجي بين البقاء في بيته والعودة إلى المغامرة فإنه سيختار أن يكرر المحاولة.
لم يقل أحد لأحد ما معنى أن يكون المرء لاجئا كل حياته. بل إن أولاده وأحفاده سيكونون لاجئين دائما. ذلك إرث لا يُستهان به على مستوى المعاني الإنسانية. غير أن الكارثة تكون أكبر حين يتم النظر إلى الأوطان الطاردة التي لا تبدي اهتماما بمصائر مواطنيها. غير زعيم عربي قالها بصراحة “مَن لا تعجبه الأوضاع فليرحل” كما لو أن الوطن بيت شخصي ورثه أولئك الزعماء عن آبائهم. هو ملكهم الشخصي الذي يجب ألا ينافسهم أحد عليه.
أليس من الصعب القبول بمعادلة لاجئ من بلد ثري؟ لقد امتلأت مدن غربية بالصوماليين وصاروا مواطنين مزعجين بالرغم من أنهم يستهلكون كميات من اللحم البقري في الأسبوع بما يعادل ما يستهلكه سكان تلك المدن لمدة سنة. سيُقال دائما إن الصوماليين أبناء بلاد فقيرة أما العراقيون فإن النظر إليهم باعتبارهم أبناء بلاد ثرية سيكون محل شك دائما. لم تنته محنتهم بالرغم من أن الكثيرين منهم صاروا يعيشون حياة مواطن ثري مهاجر. لمَ التمسك إذاً بهوية اللاجئ؟
يعرف أردوغان أن اللجوء صار لعبة مربحة. قبل سنوات قبض ثلاثة مليارات يورو رشوة من الاتحاد الأوروبي من أجل أن يوقف موجات اللجوء السورية. أما حين أعلنت المستشارة الألمانية ميركل عن استعدادها لاستقبال مليون لاجئ سوري فإن ذلك فتح شهية المواطنين للتخلي عن مواطنتهم.
لاجئون من أجل لا شيء. ليس صحيحا. كل لاجئ هو رقم في معادلة دولية ستُمحى من بعدها الأوطان ليكون الجميع من غير وطن.
فاروق يوسف – كاتب عراقي – العرب اللندنية
المقالة تعبر عن رأي الكاتب والصحيفة